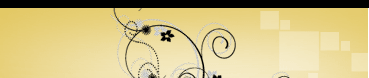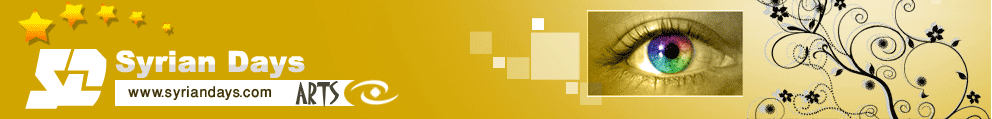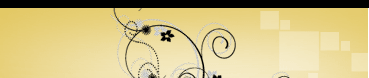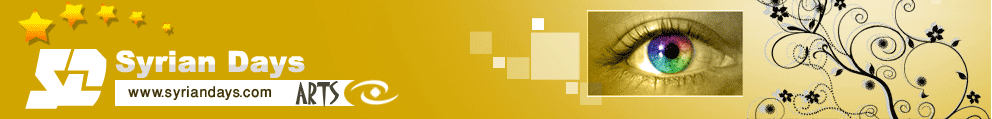بقلم: الناقد والإعلامي سمير المحمود
بداية وقبل الحديث عن مسلسل "لست جارية" الذي هو موضوع مقالتنا هذه.. من المهم الإشارة إلى أن فكرته العامة وخطوطه الدرامية العريضة مقتبسة عن قصّة حقيقية، وجسّد الأدوار فيه عدد من كبار نجوم الفن في سورية نذكر منهم: عبد المنعم عمايري، كندا حنّا، أحمد رافع، رنا شميس، سوسن ميخائيل، إمارات رزق، يزن خليل، تولين البكري، رشا بلال، مديحة كنيفاتي، عهد ديب، يامن سليمان، يوسف عسّاف، مي مرهج، وفاء بشّور، ريم معروف،.. وآخرين..
في هذا العمل الذي قامت بإنتاجه المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في سورية بإشراف الإعلامية السورية القديرة ديانا جبور، بالشراكة مع مؤسسة الفارس السينمائي التي يملكها ويديرها المخرج ناجي طعمي،.. نلحظ بشكل محايث ومساوق اصطراع وظيفتي الدرامي المتخيل، والمرجعي "القصة الحقيقية"، حيث ينهض الصوغ الأسلوبي في الإخراج لهذه الوحدة باستيعاب حوار داخلي متنامي بين بنيات فنية بصرية وقوالب تعبيرية إيحائية تضفي على سيرورة التشكل الدرامي المتصاعد باتجاه الحبكة طابع اللاتمركز، متخذاً منحى يراهن على المزج والتداخل بين التشكيل الفني للصورة والسياق العام للحدث، باشتغال شبه متعالي على ضوابط النوع الدرامي التقليدي، وكأنّ صناع المسلسل أرادوا في هذا العمل إعادة تجنيس النوع الدرامي من خارج حدوده الكلاسيكية ابتغاء معانقة مطلقية الحكائية السردية للسير الذاتية؛ حيث نلحظ أنهم قد اتخذوا منطقاً فنياً سينمادراماتيكياً لا يمكن وصفه بأنه متمرد على قواعد اللعبة بقدر ما يمكن القول عنه بأنه يؤسس لمعيارية جديدة تصهر الوحدة الأسلوبية ضمن صوغها الحواري البصري بفنيات زخرفية تؤدي إبلاغات رسائلها وفق قوالب وبنيات جمالية متنوعة في أفق لا نهائية التعبير الإيمائي الممتزج بالحوار الموضوعي لسياق السرد الدرامي... ففي إحدى الجزر السكنيّة المطلّة على ضاحية الشام الجديدة، اختار المخرج ناجي طعمي أن توحي إضاءة اللوكيشن بالكآبة، عاكسةً صراع البطلين عبد المنعم عمايري (غالب)، وكندا حنّا (ميس)، والتناقض بين السواد الطاغي الذي يشيعه سلوك الزوج، ومساحة بياض تسعى الزوجة إلى فرضها، والتمسك بها حفاظاً على أسرتها... من الواضح أن الإشباع اللوني للفنية الصورية في "لست جارية" هو أحد أهم العناصر الأسلوبية التي تحمل جوانيات الرسالة التي يريد إيصالها صناع العمل للمتلقي، فالأنساق اللونية للإكسسورات والتوزيع الهارموني للضوء والديكور بأبعاده الزمانية والمكانية في فضاء الجو الدرامي للعمل، كلها ترسل شيفراتها السحرية لعين المتلقي فتتكامل الصورة البصرية عنده ليتكامل الخطاب الفني الدرامي في التفاعل مع خياله... على أن المرتكزات الأساسية التي اعتمدها صناع العمل والتي قدموا من خلالها خطابهم البصري بكل ما يحمله من هواجس ومشاعر وأحاسيس وانفعالات صاغوا منها مضامين إنسانية وجودية عميقة تخاطب وجدانيات الوعي الكلي لفلسفة الحس الإنساني، عبر تصوير ما يجيش في نفسيات شخوص الحكاية من مخاوف وتوجس وقلق ومداراة ومعاناة وغضب وانفعالات حيث تنصبغ معظم بداية المشاهد بلون يشي بشيء من الكآبة، وتنتهي معظمها بما يشي إلى الانفراج وهدوء النفس، مارّة بما يمكن به أن تتلاقى كل المشاعر والأحاسيس،..

المخرج بالتعاون مع كادره الفني راحوا يلعبون لعبتهم الفنية مع دواخل النفس البشرية وجيشانها في مجاهل الروح بعمقها التأملي وما يتمخض عنه من منعكسات أمام التجارب الحياتية المعيشة، وفي العقل البشري الذي يكون فيه الشعور واللاشعور وجهان لعملة واحدة، فعبر أدوات الكادر الفني من إكسسوار وديكور وإضاءة إضافة لجهود الفنانين في الإيحاء، وباشتغال دقيق ومهنية عالية من المخرج في رصد الملامح التعبيرية التي تنعكس فيها ألوان الأطياف الضوئية للكاميرا بتوافق متقن مع الإكسسوارات المرافقة لملامح الوجوه كمدلول يرمز إلى دال.. حيث تتوزع مساحات السطوع اللوني للإضاءة في المَشَاهد بهارمونية درامية أخّاذة تجذب إليها المتلقي نفساً وعقلاً أمام تجلياتها التعبيرية، ليقف مبهوراً بهذا التوزيع بين انسجام ألوانها وتناقضاتها ما بين الشاحب والزاهي آخذة في عمقها حركية للتعبير عن حقيقة النفس الإنسانية التي تتجاذبها قوّتان؛ قوة الدفع التي تشي بشكلٍ أو بآخر إلى الأعراف التقليدية للمجتمع بكل سلبيتها ونكوصها وأنانيتها وضيق أفقها، وقوة الجذب التي تتلقفه بكامل بريقها إلى التمرد على تلك التابوات لبلوغ الحالة الرهيفة والمضيئة لجمال الحياة وأناقتها وسمو حضارتها،.. إن المعاني والدلالات التي تحاول أن تولّدها هذه الصيغة الإخراجية للصورة في ذهن المتلقي تعتمد على الصلة التي تربط الفكرة المرصودة المراد بلوغها، والبيئة الزمكانية التي يوجد فيها الإثنان؛ الصورة/المشهد، والمتلقي،... فتأتي تلك الاشتغاليات بتجلياتها الدرامية كمرآة عاكسة لفكرة السياق السردي لتفاصيل الحكاية، حيث العلاقة بين ميس وغالب (كندا وعمايري) كانت تنطوي على حبٍّ كبير، تتكلل بالزواج، إلا أنّ هذا الزواج يتحوّل إلى مأساة، حين يكتشف الزوج ليلة الزفاف أنّ عروسه تخفي سراً كبيراً، ما يجعل حياتها معه جحيماً، بعد رضوخها لشرطه تحت وطأة شعورها بالذنب والبقاء مدى العمر جاريةً له، أملاً منها في استعادة حبّه لها، سالكةً كل السبل المؤدية لذلك، حتى على حساب كرامتها وأنوثتها، فرحٌ قليل، ابتساماتٌ شبه نادرة، ودموعٌ كثيرةٌ تذرفها كندا مشهداً تلو الآخر أمام عمايري، من الواضح أن هذين الدورين قد تطلّبا اشتغالاً كبيراً على المستوى النفسي، حيث أجادت كندا بشكل لافت أداء أدوار الفتيات القويّات، والمتمرّدات بشكلٍ أو بآخر، على أن ميس التي تجسدها كندا لا تعتبر ضعيفة، بل تتجسد فيها قوة المرأة التي يمنحها إياها الحب للحفاظ على وجودها، وعائلتها، وشريكها، وتتحمل لأجل ذلك الإهانات، والقسوة، والاستفزازات المتكررة من حبيبٍ أصبح زوجها، اقتناعاً منها بأنّها المسؤولة عمّا يحدث، وليس هو، في حين أن الزوج "غالب" الذي يجسد شخصيته عمايري هو ضحيّة لمجموعة تقاليد وأعراف اجتماعية شرقيّة، تشكل له عقدة وتجعله يعاني ما يشبه الوسواس القهري بسبب تلك الأعراف التي لا يستطيع تجاوزها كغالبية الشباب العربي، لذلك لم يتمكّن من تقبّل واقع اصطدم به ليلة زفافه، بعد اكتشافه سراً أخفته حبيبته عنه، فيقابلها بسلوك عدائي، يعززه استعداده النفسي لهذا السلوك نتيجة نشأته في جو مشحونٍ بالعنف الذي طالما مارسه والده تجاه والدته، فيتحوّل في النهاية إلى شخص مريض نفسياً،... من جهة أخرى نلحظ أن هذا العمل الذي يتخذ من مأساة ميس وعلاقاتها المتشعبّة بمن حولها؛ إطاراً عامّاً لحكاية يلخصّها الكاتب بمناقشة قضية انقلاب القيم في مجتمعاتنا العربية المعاصرة، وانحسار مفهوم الشرف بحيث لم يعد يشمل إلا ما يتعلق بالمرأة، وهو "أي العمل" في الوقت نفسه يعريّ ازداوجية المجتمعات العربية عبر ثلاثة محاور رئيسية؛ علاقة "ميس" الفنانة كندة حنّا بـ"غالب" الفنان عبد المنعم عمايري التي تحدثنا عنها آنفاً... بالمقابل يخوض المسلسل في عوالم الفساد، والصراع الطبقي عبر شخصيتي والديهما، وعلاقة كلٍّ منهما بأسرته؛ راسماً صورة بانورامية عن مجتمعٍ مختل، يتغلغل الجهل والتخلف والنكوص والقهقرى داخل خليته الأساس "الأسرة"... أزمات نفسية واجتماعية وأسرية عدّة، تعاني منها المجتمعات العربية، مهدّت من دون أدنى شك لما وصلت إليه حال هذه الأسرة. كما أن سطوة مفهوم المال والتخلّف الذي ساد تلك المجتمعات، لا بد أنّ انعكاساتها ظهرت في ظرف طارئ عاشته البلاد، فانقلبت الموازين والمفاهيم،.. هذا ما حاول مسلسل «لست جارية» الذي كتبه فتح الله عمر إيصاله عبر مجموعة من قصص الحبّ المبنيّة على ردود فعل متفاوتة، مع صراع طبقي نسجه ليشكّل "حدّوتة" العمل... إذن المرأة وقضاياها العنصر المعني الأكبر بمعظم تفاصيل العمل إن لم نقل كله، والذي تشكّل حكاية ميس البوابة الأكبر له. على أن غالب الذي تحوّل إلى رجل شبه مريض نفسياً بعد اكتشافه لسرّ حبيبته/زوجته ميس يخوض علاقاتٍ نسائية متعدّدة، تحت سطوة مفهوم الذكورية ومنها علاقته مع صفاء التي تجسّد شخصيتها الفنانة عهد ديب، وهي صديقة ميس لكنها تعيش علاقة حبّ مع زوجها وتتطوّر،.. وهنا تتوضح خطوط الحياة الخاصة لـ"غالب" و"صفاء"، ويرى المُشاهد خيانة الزوج ومشاكل المرأة وكيف تصل هذه الأمور إلى مرحلة تجاوز العادات والتقاليد المحيطة بها بجرأة كبيرة يتميّز العمل بخوضها... وفي خطّ موازٍ لـ"ميس" التي يخونها زوجها بأكثر من علاقة مع نساء عديدات، تعيش أختها "سوسن" الفنانة رشا بلال علاقة حبّ مع «معن» يوسف عساف ، ولكنّها على العكس من شخصية «ميس» تماماً. فهي متمرّدة وقوية، تقف في وجه والدها «أبو نورس» عبد الهادي الصبّاغ المتسلّط بشدّة، بمساعدة أخيها «نورس» يزن خليل، وعلى رغم تعرّضها للضرب من والدها كي تتخلّى عن حبيبها وتتزوّج بصديق الأب الغنيّ والمسنّ، إلا أنها ترفض بداية فكرة الهروب حفاظاً على سمعة عائلتها الملتزمة بالعادات والتقاليد. ولكن مع ازدياد ضغط والدها، وحين اتخاذ قرارها بالهروب مع الحبيب، يتدخّل القدر بظرف صحّي يتعرّض له والدها يثنيها عن ذلك الفعل... النهاية تكون سعيدة لقصة «سوسن» بمساعدة أخيها «نورس» وأمّها الفنانة هناء نصور التي تتحمّل أعباء الحياة وظلم الرجل المتخلّف الشرقيّ، فترضخ له على الرغم أنه يعاملها كجارية، وتقبل بقسمتها، إذ تزوجت في سن الرابعة عشر، بطريقة شديدة التخلّف.. أمّ نورس تبقى راضخة للزوج إلى أن تراه يبدأ بتدمير أبنائها واحداً تلو الآخر. فإما أن يرضخوا له أو أن يدمّر حياتهم. وهنا تنتفض في وجهه وتقف إلى صفّ أبنائها، وتزوّجهم كما اختاروا هم، لتكون نموذجاً للمرأة الصامدة التي تنال رضا أبنائها وتحقّق طموحاتهم باختياراتهم هم، لا اختيار والدهم، فهي لن تقبل أن يعيش أبناؤها كما عاشت هي... ولم يقدّم العمل الرجل فقط كضحية للعادات والتقاليد وصراع الآباء الذي ينعكس مرضاً نفسياً على حياة الأبناء، بل المرأة أيضاً تعيش تلك الأزمات، إذ تشكّل خلافات والديّ «غالب» عقدة نفسية لأخته منى الفنانة رنا شميس تجاه الرجل. ويتضح ذلك عبر علاقتها بالفنان "مجد حنا" ابن الطبقة الفقيرة جدّاً، على رغم أنّه حبّها الأول، لكنها تساعده في رشوة أستاذه الجامعي للتخرّج من كلّية الهندسة لينتهي به المطاف في السجن.. وتلك العقد تجاهه تظهر على الرغم أنّ شخصية مجد تنمّ عن شاب محافظ على كرامته ومناصر للحق. نراه انفعالياً على الحقّ، ويتصرف بحكمة ليبقى محافظاً على سمعة عائلته... تؤدي دور حنان أم غالب الممثلة السوريّة ضحى الدبس، حيث تقدّم هذه الشخصية بعيداً عن الصورة النمطية للمرأة المعنّفة، فرغم ملامح الانكسار في عينيها، إلا أنّها كأمّ تنتزع لحظات القوة كي تبقى واقفةً إلى جانب ولديها، وتوجههما، رغم إمعان أفعالهما في تحطيمها.. في المقابل تظهر عائلة بشير مهران الفنان "أحمد رافع" كمن تقاوم الطوفان، حيث يتعين على الرجل مواجهة عدوانية أبو نورس، بالتوازي مع عقباتٍ كثيرة تعترض جهوده في تنشئة أسرة صالحة، أهمها تحكم قانون الشارع بتربية الأولاد ضمن هذا الإطار... كما يحمل العمل خطّاً في عالم الجريمة، إذ يشهد وقوع جريمة قتل يكشفها النقيب «بلال» الفنان "مضر ناجي جبر" الذي يتّسم بشخصية شبه فاسدة، فيتعامل بشفافية مع بعض القضايا ليستفيد من قضايا أخرى. ويحاول الفنان مضر الظهور بطريقة مختلفة عن الصورة التي قُدّمت بها شخصية النقيب سابقاً...
.jpg)
طبعاً هذا ما يظهر على السطح من حيث الفعل والسياق والسرد والحدث... أما لو حاولنا استكناه العمل غوصاً وتحليلاً فسوف نجد أنه يحمل في العمق فلسفة اجتماعية تركز كثيراً على البعد النفسي المتساوق مع التابوات وانعكاساته على السلوك، منها تحذيرية ومنها نقدية ومنها توعوية.. فمظاهر التلوين المشبع بالإحساس النفسي في ملامح الوجوه أثناء الحوار الفني، هو حوار الإضاءة والديكور بشكل أجناسي تتبادل فيه العناصر الفنية إبلاغات جمالياتها الممتلئة بكل تفاصيل الحياة فتغدو الصورة الملتقطة ببعديها القريب والبعيد مسرحاً للاحتفاء واللعب المرآوي مع النفس...
علماً بأنه لو بدأنا من العنوان كعتبة مفتاحية للمسنا ضمناً وبشكل مباشر أن العمل يمسّ هماً تعاني منه النساء إلى حد ما بشكل عام أو هو يعالج بشكل أو بآخر الأنثى في علاقتها مع الرجل وسوف يقفز إلى ساحة الحدس الحسي بأن العمل يرصد إحدى لوحات التخلف الاجتماعي الخاص بعالم المرأة، فالعنوان في إطاره العام هو بمثابة استدلال تم نحته بشكل متقن ليشكل بصياغته جذباً لأكبر كم من مجتمع النساء للمتابعة وكأنه يقول لتلك الشريحة بأنه يعمل على محاكاة همومها وشجونها ومعاناتها، وفي هذا نرى أن صناع العمل وفقوا في صياغة وبناء عنوان يلخص السياق الدرامي للعمل،.. الجدير تسليط الضوء عليه هنا هو إن معظم الأبحاث والدراسات الحديثة في نظريات القراءة وعلوم السيمياء وجماليات التلقي، أولت أهمية كبيرة للعنوان وتم اعتباره مكوناً أساسياً ودالاً لا يمكن التغاضي عنه في أية قراءة نقدية، وتكمن أهمية العنوان في كونه أول المؤشرات التي تدخل في حوار مع المتلقي فتثير فيه نوعاً من الإغراء والفضول العلمي والمعرفي، وإليه توكل في كثير من الأحيان مهمة نجاح المروّج الإعلامي في إثارة استجابة المتلقي بالإقبال عليه، أو النفور منه واستهجانه.. فالعنوان يشكل سلطة المتن وواجهته الإعلامية، كما أنه الجزء الدال من العمل، وهذا ما يؤهله للكشف عن طبيعة العمل، وفي كثير من الأحيان يعيّن مجموع السياق السردي للفعل الدرامي ويظهر غايته وأهدافه، وبهذا يمكن عدّ العنوان بأنه مرآة النسيج العام لأي عمل درامي، ومن كونه يشكل الدافع لفضول وإثارة المتلقي، فهو بلا شك يمكن عدّه المفتاح في التعامل مع أي عمل في بعديه الدلالي والرمزي، بحيث لا يمكن لأي ناقد أن يلج عوالم العمل الدرامي، وتفكيك بنياته التركيبية والدلالية، واستكشاف مدلولاته ومقاصدها التداولية، دون امتلاك المفتاح الذي هو العنوان،..
.jpg)
وهذا ما يتحقق تماماً في "لست جارية" حيث يشكل إسم العمل "العنوان" الثريا التي تضيء فضاء المخيلة، وتساعدها على استكشاف أغواره، فيكون قد ساعد لوحده على اقتحام عوالم العمل؛ لأنه بكل بساطة لمجرد أن يذكر نلحظ أن المخيلة قد استحضرت كامل مرفقاته الدلالية والإشارية.. من المهم الإشارة هنا إلى أن العنوان هو منطلق ضروري للقراءة بالنظر إلى الوظائف التي يؤديها، من حيث الإغراء والإيحاء والوصف والتعيين،.. كما أنه يؤدي وظيفة مرجعية تركز على الموضوع، ووظيفة ندائية تركز على منعكسات ذائقة المتلقي، ووظيفة تحريضية من حيث حث فضوله وجذبه ومناداته،... في "لست جارية" نجد أن العنوان إضافة إلى تحقيقه كل هذه الوظائف نجد بأنه يشكل في دلالته وإيحاءاته البنية الرحمية لما سيأتي في السياق من أحداث، وبالتالي نلحظ كيف أن سلطته تلك بمجموع ما يعتمل داخل بنيته الدلالية واجهه إعلامية شاملة لما سيقدمه العمل، محققاً بذلك وظيفة أخرى ليست بأقل من الوظائف السابق ذكرها، يمكن تسميتها بالوظيفة التواصلية التي تعمل على تبئير انتباه المتلقي وربط نوع من التواصل بينه وبين العمل، بشكل كلاني على مدار بث كامل الحلقات، إضافة إلى خلق نوع من التقارب بين الفكرة العامة للحكاية والمتلقي، لأن في العنوان نلحظ تلك الدلالة التحريضية لخيال المتلقي التي تعمل بشكل أو بآخر على تقليص المسافة بينه وبين الحكاية...
في الختام لا يمكنني إلا أن أقول بأن العمل ليس يحمل فقط البذور الأولية لنمو وعي جديد بالانعكاس الفني بل هو نمط متقن من اللعب الإخراجي الذي يحرص على أن تكتفي فيه الإيماءات بالإحالة على صورتها الداخلية، وما تبطن تلك الصورة من ملامح إشارية ودلالات، جاعلة بذلك من الإطار العام للصورة في حد ذاتها مرتكزاً أساساً ليس أقل من الهدف الأساس لمجمل العمل... هو لعب فني على مرآة الروح الاجتماعية بكامل مرتكزاتها التربوية، تلك المرآة المصبوغة نفسياً بما يمكن تسميته بـ"نرجسية" المتخيل، وفي ذلك ما يؤشر إلى تفاعل هذا العمل مع أفق انتظار عالم جديد من التقانة الفنية، لصناعة جمالية تشكيل مشهدية مركبة من اللون والملامح والتعابير اللونية المتوافقة مع البعد النفسي للحالة الحوارية أو لحالة الفكرة المرافقة للحدث،.. بهذا الاعتبار يمكننا التنبؤ أنه يمكن لهذه الدراما إذا ما قفزت بهذا الاتجاه ربما ستسبق نظيراتها من الدرامات التركية والهندية والإيطالية والمكسيكية التي تلعب بتقانة منقطعة النظير على هذا الصعيد، على أن الأعمال الهندية هي الأعلى تقانة في هذا النسق،.. بكل الأحوال من الممكن جداً تطور هذا التنويع الفني إن تم إتقانه فهو بحق ليس أقل من المحمول والفكرة والسرد والحوار على مستوى توظيف الإشتغال اللوني في صناعة فرجة بصرية ممتعة لعين المشاهد وفي الوقت نفسه تخاطب حسه النفسي والذوقي والفكري والتأملي، فهو يجعل الخيال ككلٍّ يتأمل صورته المكررة في مرآة السرد الدرامي وكأنه حالة انعكاس لما تحمله الذاكرة من تجارب سابقة وأحياناً آنية أو لحظية متوافقة مع خط سير الحدث الدرامي لحظة البث إلى ما لا نهاية،.. إن هذا الانزياح بين النظام التصويري والنظام الخطابي المتنوع بصرياً في هذا العمل يتيح إمكانية مضاعفة القراءة الأكثر فلسفة والأكثر انتساباً للتحليل النفسي من المتلقي بكل مستوياته بما فيه الناقد المحترف.